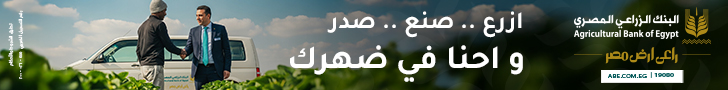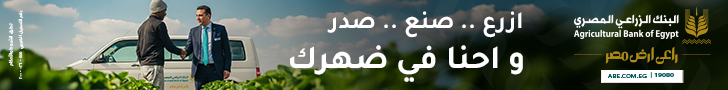بقلم – الدكتور عادل عامر
ما أن استشعر الشعب المصري بأن هناك خطراً يحيق بالوطن، وأن الرئيس الأسبق وجماعته باتا يشكلا تهديداً خطيراً للسلم والأمن العام في المجتمع المصري. أطلق الشعب المصري ثورته في 30 يونيو ، ليصنع تاريخه من جديد، ودوت في جميع ميادين القاهرة والمحافظات هتافات موحدة لملايين المتظاهرين التي أعلنت تمردها، وطالبت بسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة . فقد رسخ حكم مرسي علي مدار عام حالة من الاستقطاب الحاد، وقسم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامي الذي أطلقوا عليه مشروع النهضة ويمثله الرئيس وجماعته دون أن يقدموا دليلاً واحداً علي هذا المشروع.، وبين قسم آخر مناهض له . وبدلاً من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج، اتجه إلي التناحر والعراك بين التأييد والرفض.
عمل حكم مرسي وبسرعة كبيرة علي ترسيخ الأخونة ونشر هذا الفكر رغم تنامي الشعور المعادي له من يوم لآخر. كثيراً ما تحدث حكم مرسي عن أمر وفعل نقيضه في الحال، وابرز مثال علي ذلك الحديث عن حماية الأقباط، واستهداف دور عبادتهم في ذات الوقت.
شهدت مصر خلال عام من حكم مرسي أعمالاً فوضوية وهمجية غير مسبوقة بعضها كان بتحريض من الرئيس وجماعته كحادث قتل الشيعة بالجيزة.
إن مجمل ما حدث وما يحدث الآن من تفاعلات وتطورات، كانت بدايتها تفجر موجة الثورات العربية، ينبئ بحتمية تداعي النظام العربي الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية نتيجة لتداعي أنظمة حكم مستبدة وفاسدة أسقطتها إرادة الشعوب، لكن أي بديل سيفرض نفسه بعد أن تستقر الأوضاع في الوطن العربي سيبقى أمره محكومًا بما سوف تؤول إليه تلك الموجة، الثورية، بانتصاراتها وتعثراتها بل وانتكاساتها، كما ينبئ بحتمية تغير هيكلية النظام الإقليمي للشرق الأوسط وأدوار القوى الثلاث الكبرى الفاعلة:
إيران وتركيا وإسرائيل التي تشكل الآن قلب أو محور هذا النظام، وخرائط التحالفات والصراعات التي تربط بين هذه القوى والدول العربية، وكذلك أنماط العلاقات والتفاعلات المحتملة بين النظام العربي الجديد وذلك النظام المتوقع للشرق الأوسط من منظور التأثير المتبادل أو التبعية، وفرص ظهور قوة أو قوى عربية قادرة على مبادلة القوى الثلاثة الفعل والتأثير خاصة مصر التي سيتوقف عليها حسم معظم التساؤلات المثارة الآن بخصوص مستقبل النظام العربي والتأسيس لخرائط تحالفات وصراعات جديدة في الشرق الأوسط، وفقًا للسيناريوهات المحتملة لمستقبل التغيير في مصر.
فقد استطاعت تنظيمات وأحزاب التيار الإسلامي اقتناص بعض الثورات والسيطرة عليها تحت شعار “شرعية الصناديق” وإقصاء كل القوى الثورية والسياسية الأخرى ضاربة عرض الحائط بكل وعود “الشراكة الوطنية الجامعة” التي وعدت بها، وبكل ما يمكن اعتباره شروطًا موضوعية لنجاح الثورات، وفي مقدمتها ضرورة التوافق الوطني على مرحلة انتقالية في إدارة الدولة يكون الحكم فيها وفقًا للشراكة الوطنية وبعد انقضاء هذه الفترة، التي قد تمتد إلى خمس سنوات تهيَّأ فيها الدولة الانخراط في الحكم الديمقراطي وفق قاعدة التنافس الانتخابي، تبدأ المرحلة الجديدة من الحكم بالقواعد التي يكون قد تم التوافق عليها في دستور وطني ديمقراطي يعد بمثابة عقد سياسي – اجتماعي جديد بين كل المكونات الشعبية للدولة. فقد تلاقت مواقف تركيا مع مواقف كل من إيران وإسرائيل في إدراك مدى تأثير الثورات العربية على تركيا ومصالحها في المنطقة، واهتمت بما سوف تؤول إليه تلك الثورات من تطورات وخاصة شكل الحكم الجديد، وموضوع الديمقراطية، والإسلام ونظم الحكم، والعلاقة بين الجيش والسياسة في تلك النظم الجديدة، لكن كانت المصالح القومية التركية هي العامل الحاكم لمواقف تركيا وبالذات ما يتعلق بالدور التركي الإقليمي وتحالفات تركيا الإقليمية.
فإذا كانت تركيا قد تفاءلت كثيرًا مثل إيران بالثورة في كل من تونس ومصر، فإن التحسب والتريث كانا عاملين حاكمين للمواقف التركية من الثورتين الليبية واليمنية والأحداث البحرينية، أما الأمر بالنسبة لسوريا فقد بات محكومًا بحزمة مصالح واسعة إستراتيجية واقتصادية وأمنية بين البلدين، لكن الموقف من الثورة المصرية بعد إسقاط حكم الإخوان كان ذروة الانكشاف للموقف التركي. .
ويعتقد ميد أن العلاقات مع الرياض كانت أكثر تعقيدًا، فالإدارة الأمريكية لم تراعِ تخوفات المملكة العربية السعودية من تزايد نفوذ تركيا وجماعة الإخوان المسلمين بالمنطقة، وعطفًا على هذا عندما اختارت واشنطن التحالف مع تركيا ومحمد مرسي في مصر كان هذا يعني وضع قيود وخصمًا من حرية حركة الساسة السعوديين في الإقليم لحساب دول أخرى مجاورة مثل قطر التي تطمح لانتزاع المبادرة الدبلوماسية من جارتها الأقوى والأكثر تاثيرًا (المملكة السعودية).
وفي هذا السياق يقول الكاتب إن أغلب الأمريكيين لا يدركون مدى الكره الذي يكنه المسئولون السعوديون لجماعة الإخوان، وللإسلاميين في تركيا؛ حيث سيطر على الرياض لفترة طويلة اعتقاد راسخ بأن جماعة الإخوان تشكل تهديدًا سياسيًّا في عالم الإسلام السني، كما أن طموح رئيس الوزراء التركي أردوغان -المرتبط بإحياء مجد الإمبراطورية العثمانية، وتحويل مركز الثقل في العالم الإسلامي إلى تركيا- لا يمكن أن ترتضيه المملكة السعودية، لأنه تهديد مباشر لنفوذها، ومن ناحية أخرى فإن دعم واشنطن للتحالف القطري مع تركيا وجماعة الإخوان المسلمين في مصر أغضب المملكة السعودية بصورة أكبر، وهو ما جعلها تنضم إلى الطرف غير الداعم لأهداف الدبلوماسية الأمريكية، ولم يكن هذا الأمر غائبًا عن مشهد 30 يونيو في مصر، فالمملكة تحالفت مع المؤسسة العسكرية (عقب إطاحة الأخيرة بالرئيس السابق محمد مرسي) ووجدت في هذا التحالف فرصة للإطاحة بمحور قطر والإخوان والأتراك المدعوم من الولايات المتحدة.
أما الحالة المصرية، فإن الموقف الروسي اختلف حيال ثورتي 25 يناير و30 يونيو بدرجة كبيرة. فعلى الرغم من الحذر الشديد الذي بدا على السياسة الروسية منذ اندلاع الاحتجاجات في مصر في 25 يناير 2011، وعدم إصدار أية ردود أفعال مؤيدة أو معارضة، وإنما اكتفت بالمراقبة وانتظار ما ستسفر عنه؛ إلا أنها سارعت مع اندلاع الاحتجاجات في 30 يونيو 2013 إلى تأييد التحرك الشعبي المصري ومساندته، وهو الأمر الذي أعطى لروسيا أرضية على المستويين الشعبي والرسمي على حساب الولايات المتحدة. ويرجع هذا الاختلاف الجذري في الموقف الروسي إلى أن الارتباك وتسارع الأحداث الذي صاحب ثورة 25 يناير جعل من الصعب على السياسة الروسية قراءة المشهد والتنبؤ باحتمالاته المستقبلة، خاصة وأن نظام مبارك كان حليفاً للولايات المتحدة. أما المشهد السياسي المصري بعد قيام ثورة 30 يونيو فقد كان فرصة ذهبية أمام القيادة الروسية لعدة أسباب،
أولاً: عدم الارتياح الروسي لوصول الإخوان المسلمين –المصنفة كمنظمة إرهابية لدى روسيا- إلى سدة الحكم في مصر،
ثانياً: أن الاحتجاجات المصرية وُجِّهت أيضاً للولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي للإخوان المسلمين، وطالبت بالخروج من تحت عباءتها،
ثالثاً: موقف القوى الكبرى في العالم (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) الواصف لثورة 30 يونيو بالانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب في ظل رفض شعبي تام لذلك الوصف، فتح الباب على مصرعيه أمام روسيا من أجل وضع قدم في الشرق الأوسط كداعم وحليف مستقبلي لأكبر دولة محورية فيه،
رابعاً: أن فقدان الولايات المتحدة لمصر كحليف واتجاه الأخيرة نحو روسيا، سيتبعه بالضرورة انتهاج العديد من الدول العربية لذات التوجه، خامساً، أنه في حال نجاح المعارضة السورية في الوصول للسلطة على حساب نظام الأسد الحليف لروسيا، فإن مساندة مصر يضمن لها عدم الخروج خاوية اليد من الشرق الأوسط.
أن إسرائيل من الداخل ترى أن مصار الخلاف المختلفة تتمثل في وجود أزمة حقيقية داخل تركيا، وهو ما ينعكس على ما بعد المصالحة، كما تتوقع إسرائيل فشل رجب طيب أردوغان. وأضاف المتحدث أن هناك رهانا إسرائيليا على قدرة أردوغان على تجاوز الأزمة الحالية، وترى في النظام الإقليمي في تشكيل مجلس أعلى للسياسات، وتقارب إيراني- تركي تأثيرا في العلاقات الإسرائيلية- التركية
في ظل وجود مجموعة من الدوافع الاقتصادية للتقارب الإسرائيلي- التركي (استثمارات متبادلة- تأمين الحصول على الطاقة والنفط) أن تركيا حالياً تشهد تحولاً من الدولة العميقة إلى الدولة الموازية التي شكلها فتح الله جولان، من خلال التغلغل في مؤسسات الدولة المهمة لتقويض تجربة حزب العدالة والتنمية. وقد حدث ذلك في ظل وجود حالة من الغضب الشعبي تجاه سياسات أردوغان الداخلية والإقليمية، وغياب التوافق الوطني حول هذه السياسات، وعدم بلورة سياسة خارجية تركية ناجحة.
وتعد منطقة الشرق الأوسط الأكثر قابلية للتأثر بإرهاص متغيرات النظام العالمي بحكم قدراتها وإمكانياتها المحدودة، وضعف تماسكها، لاسيما اقتصاديا وسياسيا، واتساع نطاق وعمق صراعاتها(5)، وأزماتها البنيوية العميقة، والتي تكشفت حدتها خلال الأحداث والتفاعلات الجارية في ساحتها، وتجلت مواطنها بين هويات وطنية (قطرية)، وقومية (عربية)، ودينية (إسلامية) متصارعة، ونزعات طائفية ومذهبية متنامية، و”تحركات” انفصالية، و”ولاءات” أولية استبدلت بالدين، أو القبيلة، أو العرق، الأمة وعاء حاضنا للهوية والانتماء، وحركات “جهادية” متطرفة تتقاطر تحت “حلم” إقامة الدولة الإسلامية
وجماعات مسلحة تتمدد في ساحات عربية بفعل التغذية الخارجية، مالا، وسلاحا، وعتادا. ولا يعد المشهد المصري وحده موطن حالة الاستقطاب الخليجي البيني الحادة إزاء تقارب الدوحة مع طهران – في ظل توافق جمعي حول الخطر الإيراني علي المعادلة الأمنية الخليجية، ومحور قطر – تركيا – التي تعدها السعودية خصمها الإقليمي اللدود. ورغم انسجام الموقف القطري، ظاهريا، مع الموقفين السعودي والإماراتي من الأزمة السورية
التي اندلعت في مارس 2011، حيال التشبث بتنحي الرئيس الأسد عن السلطة سبيلا للحل، فإنه يتقاطع معهما لجهة توظيف تسليح المعارضة لمصلحة الإطاحة بالنظام السوري، وإقامة آخر حليف لها بدعم تركي، وإنشاء خط أنابيب عبر الأراضي السورية وتركيا لتسويق الغاز القطري إلي الدول الأوروبية بأسعار تشجيعية، مما وضعها في عين العاصفة الروسية، التي يقوم اقتصادها علي تصريف غازها باتجاه أوروبا. المأساة الأمريكية والفشل الذريع جدا لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، لخلق بنى تحتية ديمقراطية من خلال القضاء على أنظمة شمولية قائمة، فشلت فشلا ذريعا. وستذكر إدارة اوباما إلى الأبد كمن فشلت تماما في سياستها الخارجية وجلبت الولايات المتحدة إلى وضع هزيل أمام العالم المنتهج وموجة التطرف الإسلامي التي تغمره بأكمله. والسنتان اللتان بقيتا للإدارة الحالية لن تغيرا من الأساس الواقع الذي نشأ في السنوات الستة الأخيرة في العالم. لا يوجد احد في العالم المتنور لا يفهم حجم الفشل في إحلال السلام من خلال سياسة مصالحة غبية تأييد عناصر متطرفة للغاية من اجل إسقاط أنظمة بدت مهددة، ولكنها عمليا كانت مرغوبة أكثر بكثير من تيار الإسلام الأصولي متعدد الأذرع الذي يبعث بأكثر الناس تزمتا إلى حملات القتل والدمار.
قبل الخطوات الأمريكية الغبية، لم يشكل العراق، سوريا، ليبيا وغيرها أبدا خطرا ملموسا على استقرار المنطقة والعالم بأسره. بحرب الخليج الأولى والثانية، إسقاط القذافي المجنون، التأييد غير المفسر لمعارضي النظام في سوريا ممن ليسوا سوى رجال القاعدة ومنظمات متطرفة، كل هذا لا يستوي مع العقل السليم.
فهل يحتمل أن يكون النظام الديمقراطي المهم جدا للأمريكيين أن يقوم في سوريا التي يسقط فيها الأسد ويستولي فيها رجال القاعدة على مكانه؟ هذه مبالغة، غباء وقصر نظر سياسي. وحتى لو لم يطب ما سنقوله لبعض الآذان فان الأسد أفضل بعشرات الإضعاف من كل زعيم إسلامي متطرف قد يصعد إلى الحكم في سوريا. وبالتالي فمن غير المفهوم لماذا يتحمس الأمريكيون لمساعدة الثوار في سوريا؟ وماذا بالنسبة للعراق، مصر، ليبيا؟ ذات الأخطاء الفظيعة للإدارات الأمريكية والسياسة الخارجية غير المعقولة وغير الناجعة على نحو ظاهر. في هذا السياق يجدر الاقتباس عما قاله دنيس روس في كتابه «عن السياسة». وقد كتب روس في مقدمة الكتاب: «لم تكن لدي ملاحظات على سلم الأولويات الأمريكية. فهل البيت الأبيض والبنتاغون تصرفا بحكمة في انتقالهم من الحرب الاضطرارية في أفغانستان إلى الحرب الاختيارية في العراق؟
 بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى