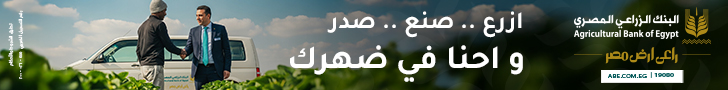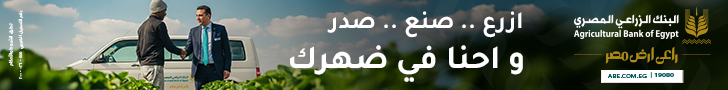بقلم : د.هشام محفوظ
قرأت العديد من التعليقات والآراء والمقالات والمقولات ذات الصلة بالاحتفاء بفوز زهران ممداني في الانتخابات الأمريكية ، ولعل هناك ما يدفعني إلى تسجيل حالة من القلق ، راجيا أن توضع في الحسبان بعض النقاط لدى أهل الخبرة في الفن السياسي والمعنيين بالشئون الجيوسياسية في هذا العالم الذي يزداد حراكا نحو المزيد من الغرائبيات..
ليس من الصعب، في منطقتنا العربية تحديدًا، أن يتحوّل حدث سياسي خارجي إلى مادة لتغذية المخيال الطائفي الداخلي. وقد ظهر هذا بوضوح في الاحتفاء بفوز زهران ممداني في الانتخابات الأميركية بوصفه «انتصارًا شيعيًا» في قلب الغرب .
إن هذا النوع من القراءة الأفقية السريعة يكتفي بالمشجب الهوياتي الظاهري ، ويتغافل عمّا يمكن تسميته “جينيالوجيا الوعي السياسي” ، أي المسار الذي تتولّد فيه الأفكار وتتشكّل عبره المواقف داخل تاريخ من الصراع وتداول السلطة .
هنا، تتبدّى المفارقة ؛ فالرجل نفسه ينتمي إلى بيئة فكرية نقدية، تشكّلت في مواجهة منطق الهوية المغلقة ، لا في تعزيزه. ولذلك لا يمكن فهم «زهران» دون قراءة المحتوى الفكري لـ«محمود ممداني» — الأب لا بوصفه أصلًا بيولوجيًا، بل بوصفه «بنية تأسيس للوعي».
أولًا: الجينيالوجيا — حين يبدأ التاريخ قبل أن نراه
محمود ممداني واحد من أبرز المفكرين الذين أعادوا قراءة الحداثة الأوروبية لا كقفزة إنسانية في مسار العقل ، بل كمنظومة تشكّلت على قاعدة الإقصاء والتطهير وإنتاج «أقليات دائمة.
فمنذ سقوط الأندلس عام 1492 بدأت أوروبا عملية تأسيس «ذاتٍ مسيطرة»، فوضعت حدود الهوية وشرعت تصنع «الآخر» الذي ينبغي نفيه أو إدارته أو احتواؤه. وهكذا وُلد آنذاك منطق:
الأمة = جماعة متجانسة ، و الأقلية = جماعة مستثناة بحكم التعريف .
من هنا، يتحوّل «التسامح» الليبرالي إلى أداة تنظيم لا اعتراف ؛ تعايش مشروط ، لا مساواة جوهرية.
وهو ما يجعل الدولة الحديثة — في جذورها — جهازًا لإدارة الاختلاف لا لتفكيك بنيته .
هذا الفهم يقوّض كل خطاب سياسي يستدعي «الأغلبية» لتبرير السلطة، سواء كانت قومية أو طائفية أو عرقية.
ثانيًا: من الأب إلى الابن — انتقال الفكرة لا انتقال العصبية .
ولذلك فزهران ممداني لم يخرج من فراغ؛ بل نشأ في بيت يرى السياسة كفضاء مساءلة، لا مساحة اصطفاف .
ولهذا فإن مقولته المركزية، وإن لم يقلها حرفيًا، هي:
لا يمكن لشكلٍ طائفي أو عرقي للسياسة أن ينتج تحررًا.
فالتحرر يبدأ من تفكيك الهوية بوصفها سلاحًا للهيمنة، لا من توظيفها كوسيلة للتمكين.
من هنا نفهم لماذا يثير زهران قلقًا في الولايات المتحدة:
ليس لأنه مسلم ، ولا لأنه «شيعي ؛ بل لأنه يحمل مشروعًا يسائل «الأسس المشرّعة للسيادة» نفسها.
في عالمٍ تُدار فيه السلطة بمنطق تفوق الأغلبية «المتخيّلة»، يأتي من يقول:
لا أغلبية ولا أقلية — بل دولة مواطنة لا تدين بالولاء لهوية واحدة.
وهذا خطاب يهدد النظام لا الهويات فقط.
ثالثًا: بعض الدول العربية كالعراق— حيث تعود الهيمنة متنكرة في ثوب الطائفة .
حين يُستقبل زهران بوصفه «ممثلًا شيعيًا» في الغرب، فإن المشكلة هنا ليست في زهران، بل في المرآة الطائفية التي تعيد إنتاج نفسها.
فالاحتفاء الطائفي به يعني:
- فشلًا في قراءة تاريخه الفكري .
- وفشلًا أعمق في قراءة لحظتنا السياسية.
لأن التشيّع السياسي— كما هو قائم في بعض المناطق العربية — لا ينتج تحررًا، بل ينتج «أغلبية متخيلة» تبرّر حق السيطرة.
بينما مشروع ممداني (الأب والابن) يقوّض فكرة أن الأغلبية تمتلك الحق السياسي لمجرد كونها أغلبية .
لهذا يصبح زهران نقيضًا موضوعيًا للتشيع السياسي عندنا، لا تعبيرًا عنه.
رابعًا: نحو أسئلة المستقبل — ما الذي يُهدّد منطق الدولة اليوم؟
إذا صحّ أن العالم يقترب من لحظة إعادة تشكّل كبرى — اقتصاديًا، ديموجرافيًا، وسياسيًا — فما الذي يعنيه ذلك لمنظومات الهوية الطائفية والقومية؟
وكيف تُعاد كتابة مفهوم «المواطنة» في عالم يتفكك مركزه التاريخي (الغرب) وتنهض أطرافه (الجنوب العالمي)؟
وما الذي سيبقى من الدولة-الأمة، إن تفككت أسطورة «الأغلبية» التي تمنحها الشرعية؟
باختصار شديد: تلك أسئلة أرجو وضعها في الاعتبار عند صياغة أي قرار سياسي مستقبلي على المستوى السياسي العربي والعالمي:
- هل يمكن تخيّل دولة ما بعد «الدولة-الأمة» دون الوقوع في الفوضى أو التفكك؟
- كيف يمكن ترجمة نموذج جنوب أفريقيا في بلدان ذات جروح طائفية مفتوحة؟
- ما الذي يجعل خطاب الهويات مغريًا رغم أنه يعيد إنتاج العنف كل مرة؟
هذه أسئلة في تصوري الشخصي لابد أن نبحث عن إجاباتها وتُكتب الإجابات بوضوح ليقراها الجميع ، لأن العالم للجميع ولا أدعي الإحاطة الكاملة بمثل هذه الأمور العميقة، لكنني أفكر في السياسة بمنطق الناقد الأدبي الذي يقرأ هذا العالم كأنه نص سردي غرائبي ضخم من نصوص الواقعية السحرية لماركيز .
…………………………..
هوامش توضيحية :
الجينيالوجيا :
تتبّع تاريخ تشكّل المفاهيم والأفكار عبر الصراعات وليس عبر السرديات الرسمية.
الدولة-الأمة:
نموذج الدولة الحديثة الذي يفترض تجانسًا قوميًّا أو دينيًا داخل حدود سياسية محددة.
الأغلبية المتخيلة:
أغلبية تُصنَع عبر الخطاب السياسي لا عبر الواقع، وتُستخدم لتبرير الهيمنة.
إدارة الاختلاف:
بأن يتم جعل التعدد تحت السيطرة بدل الاعتراف به كحق وجودي متساوٍ.
 بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى