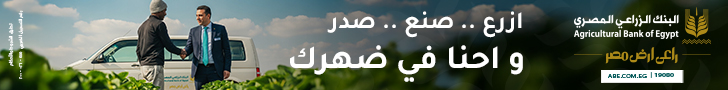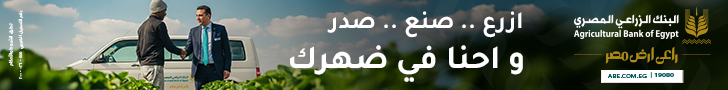بقلم الدكتور / علي إسماعيل إسماعيل درويش
مدرس النقد بكلية اللغات والترجمة
بجامعة مصر للعوم والتكنولوجيا
يعد الفن لغة إنسانية يتوحد عليها البشر من أقصى الأرض إلى أقصاها، والموسيقى والإيقاع أحد أهم الأجناس الفنية والعلامات الجمالية في الكون والحياة، فها هو الماء يهدر، والوحوش تزأر، والطيور تغرد ، والإنسان يجود ويغني ويردد، والظواهر الكونية الأرضية منها والعلوية في خطها النغمي تتساند ولا تتعاند، فالوجود بمكوناته الساكنة والمتحركة يردد معزوفة وصورة إبداعية معجزة، ولهذا كانت عناية الذوق البشري بصفة عامة والعربي بصفة خاصة بفنيات السماع والطرب، حيث شكل علم السماع عند العرب فقهاً له مدارسه واتجاهاته الفنية والفلسفية، وفي التراث العربي ما يفصح عن فتنة العرب بجمال الصوت والموسيقى، ولهذا خضع الكلام العربي عبر عصوره للذوق أكثر من خضوعه للقواعد والمنطق، فانحاز العرب إلى موسيقية الأداء وانسيابية التعبير على حساب منطقية البناء والتركيب، ذلك أن جلال الإيقاع وعراقة السماع في حياة العرب قد فاقا غيرهما من الفنون والعلوم، ومرد ذلك إلى الميل الفطري للطرب والنشوة، وعشق الارتواء من كوثر الخيال والروح، وعليه فقد أقام العرب جسوراً تربط الحدود البينية المترامية، وابتعدوا عن الحدود الواضحة المحققة، لجعل الذوق والحس معبراً للتواصل الإنساني والكوني، وبعث حيوية الوجود، والنفاذ في مسارب الجمال أينما وُجد، فإذا الإيقاع والموسيقى والطرب تهجد روحي شفيف، وهمس نفسي رهيف، وإرنان وبوح فيه من اللطافة والوداعة ما يجعل السامع مسكوناً بهذا المس المسحور، وتحت سلطانه التخديري الضاغط لا يملك إلا أن يتبعه في غواياته الجمالية الهاربة.
هذا، وقد جسدت بنية الأداء عند الشيخ الزناتي صورة صوتية متكاملة الرؤى والأبعاد، ولوحة إيقاعية يتناغم فيها التشكيل الصوتي مع الرسم الكلماتي وفق إحساس القارئ ومنهجه التعبيري في الكشف عن المعنى بالدلالات الصوتية والإيحاءات النغمية، لهذا مكنته هذه الأدوات الفذة وغيرها من الإحاطة بالقيم التعبيرية في النسق القرآني، وإجادة الترجمة له بحساسية صوتية مركبة من الالتفاتات اللحنية المستمرة والنقلات النوعية التي تجمع بين مسرحة الصوت ودراميته وسينمائية الصورة الممتزجة بروعة التمثيل الصوتي للمعاني، بهذا شكل صوت الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي مجازاً سمعياً ارتشف رحيق الجمال حتى تغلغل في بناء الجملة القرآنية سارحاً عبر طقوسه اللحنية الخاصة إلى خلاياها الطبيعية الوهاجة، متنقلاً في رشاقة وعذوبة وانسيابية لا تخلو من عناصر الدهشة والمفاجأة، استطاع القارئ بنشأته الريفية الأصلية وعزمه الفني الجاسر والآسر أن يحيل الكلمات ومستوياتها الآدائية إلى مختبرات صوتية يصل من خلالها لما يريد، كيف يريد، وقتما يريد، حيث استخلص كل ما في خلايا عسل صوته المنغوم إلى قطرات شهية مُصفاة، ليمتع بها الذائقة السمعية، ويحيلها من دور المستهلك المنتشي إلى دور المتأمل في سر قدرات الصوت والخيال والتعبير، وبهذا بنى الشيخ الزناتي على خارطه الإبداع الأدائي أهم عواصم دولة التلاوة، العاصمة الزناتية العريقة.
ولد الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي عام 1933م بقرية القطيون بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم بقراءاته المتواترة والشاذة، وتمكن من إحكام أحكامه، وقد ذاع صيت الشيخ في محافظات الدلتا في سن مبكرة، وما زال يجوب محافظاتها قارئاً، حتى انتقل إلى مدينة كفر شكر 1960م، وهو نفس العام الذي التحق فيه بالإذاعة المصرية، ليصبح الشيخ أهم موجات الأسير القرآني في مصر والعالم الإسلامي، ومن ثم علا نجمه وارتفع سهمه، فسافر إلى دول متعددة بصحبة كبار القراء، وما زال الشيخ متردداً بين أقاليم مصر ودول العالم الإسلامي حتى غربت شمس عمره في شهر مارس من عام 1990م، ويعد الشيخ رأس مدرسة في عالم التلاوة، حيث تخرج في المدرسة الزناتية عمالقة القراء أمثال محمد أحمد شبيب والشحات محمد أنور، ومحمد الليثي، ونجله محمود السعيد عبد الصمد، وغيرهم، مما يدل على عمق وعراقة أستاذيته في فن التلاوة، وفي تقديرنا الشخصي أن من أسباب ريادة الشيخ الزناتي قدرته على إحالة الجملة القرآنية المجودة إلى مشهد تتبادل فيه الحواس كل الوظائف الإدراكية، فالسمع والطرب يشترك فيهما كل من الأذن والعقل والوجدان والخيال والروح، وحينما يصعد الزناتي بصوته في جواب الجواب على مقام السيكا في طبقة التينور يسرح الصوت في عوالم غطاها بالسحر والنغم، وغسلها بماء السماء، فجاء النغم كوكباً درياً، وزهراً يتقاطر نداه عبيراً، وها هو الندى من فرط شفوفه يكاد عبقه يضئ ولو لم تمسسه نار.
ويعد صوت الشيخ الزناتي من الأصوات الذهبية الحادة ذات المساحات المتعددة، فصوته ينتمي إلى طبقة التينور التي يستولد من أرحامها جينات السماع وخفي الصور بدفقة لحنية ممزوجة بنوازع الشجن والنشوة والألم، حين يقرأ على مقام الحجاز الذي تربع على عرشه وصار أحد أئمته المتفردين، يصبح الشيخ في لحظة انكشاف صوفي وتعبيري فاتن، حيث يرتد بسامعيه إلى الإيقاع البكر موزعاً على جداريته اللحنية تنويعات باهرة صعوداً وهبوطاً مستزرعاً في رحاب الحجاز الشجرة الكونية التي تعرش عالم النفس والكون بالشدو والتردد والأثير والصدى، إذ تترسب أبعاد الإيقاع العذراء والمولَّدة في طبقات جيولوجية تعرب عن وعي سمعي يبصر التحام الحسي بالمادي، وجدلية العلاقة بين الإيقاع والدلالة، والتأسيس الزناتي للارتباط الوجودي بين الصوت والمعنى والنغم، ومن ثم يظل هذا التحول الإنساني والروحي والفكري والنغمي كاشفاً عن حياة تتهادى بسحر النغم ونماء المعاني وعبير ورد الروح، خاصة حين يشتغل الشيخ صوتياً على الأداء التبادلي المتصاعد في طبقة التينور مؤدياً بزخارف صوتية واتدادات تعمل في مناطق القرار والجواب في قوله تعالى ” وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً، فكلي واشربي وقري عيناً” هنا تتدبر جوهر المعجزة التي تتشكل في أذنيك صورة وسمعاً وصوتاً، هنا مع السرد والحكي موصولاً بثراء التطريب والإعادة والتكرار تستشعر أنك السميع على القرب والبصير على البعد لتجسيد الصوت لحركية الهز وتساقط الرطب، لتصبح شريكاً وفاعلاً في صياغة المشهد التمثيلي، وإنتاج درامية الحوار والقص القرآني وبلورته أنت والقارئ الذي يقرأ لك وحدك، وحدك فعلاً في عالمه التجويدي والإبداعي الخاص، حتى لو كنت في ملأ لا أول ولا آخر له، ولحظة ينهي بقوله تعالى ” فكلي واشربي وقري عيناً” تتأكد أن مريم تحت الجذع في حاضنة الربوبية القادرة، ومن فوقها النخلة تهديها ذوب روحها وخلاصة ما ادخرته نفسها، وتهدهد عليها حنواً وودادة وحباً.
وباستقصائنا الفاحص ورؤيتنا التحليلية والنقدية لصوت الشيخ الزناتي، نجد الشيخ قد قرأ على كل المقامات، ووظفها بطريقة آدائية انفرد بها عن مجايليه ولاحقيه، فقد بزغ نجم الشيخ في العصر الذهبي لمصطفى اسماعيل والمنشاوي والبنا وعبدالباسط وغيرهم، لكنه لم ينل حظه من الشهرة وإذاعة تلاوات كثيرة له في الإذاعة مثلهم، بسبب الخلافات بينه وبين الشيخ الحصري، والتي دفع الزناتي ضريبتها شأنه في ذلك شأن كثير من القراء المتميزين الذين كانوا ضحية هذه الخلافات ، أمثال حمدي الزامل، وشكري البرعي، وجودة المهدي، وهاشم هيبة، وأحمد صالح، ومع ذلك كله كانت للشيخ بصمته الصوتيه الخاصة في تحقيق سخاء الأداء الكيفي وجماليات الخشوع والانتشاء الطروب، فكان الشيخ من العلو بمكان في انضباط الأداء ووضوح النطق وطلاقته، ودقة التناسب الصوتي والتناظر السمعي، فارتفع وتألق في تحبير الصوت وتوشيته بالنقلات الجمالية الساحرة، وتزيينه بالخبرة الذاتية الحرة، ليكون في السمع أوقع وإلى القلب أسرع، وها أنا الآن أكتب مقالي مستأنساً بنموذج دال من تراث شيخنا يرحمه الله، فمعه في سورة الفاتحة وأوائل وآخر آية في سورة البقرة ألتقط أسرار مناجاته الفنية في عطاءات صوته القرآني المنهمر بالدهشة والشجن والطرب وبدائع الجمال.
في البداية يطالعنا الشيخ بالبسملة من مقام البياتي، ثم يستهل سورة الفاتحة بمقام الحجاز الذي يستريح ويستروح إليه، ويرسم على صفحاته ودرجاته ولوحاته الزناتية الخاصة، ثم أعاد جملة ” إياك نعبد وإياك نستعين” مرتين على مقام النهاوند واصلاً إلى قوله تعالى ” وإياك نستعين” على مقام الرصد، وما زال يستكمل على الرصد متنقلاً إلى قوله تعالى ” صراط الذين أنعمت عليهم” على مقام الحجاز من درجة القرار المنخفض، وده من ذلك كسر سكون الغفلة وبلادة العادة، ليجدد الطاقة ويحفز الذائقة السمعية على حسن استقبال هذا النغم الشهي في وجد وتدبر، ويعلن في الوقت ذاته عن أغاريد علوية ترنم بها قارئ أضاء من الفنون أركانها.
ويستأنف الشيخ توقيعاته اللحنية على أوتار القلوب، فيتلو قول الله تعالى “بسم الله الرحمن الرحيم ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه ” بالصعود إلى أعلى درجة في مقام الحجاز مع إحداث تنويعات نغمية مصحوبة بالنزول في تسلسل سُلَّمي، ومع الإعادة في قوله تعالى “الكتاب لا ريب فيه” تستمر المعزوفة الصوتية مترسمةً آداءها على الشكل التنويعي الخلاب في مقام الحجاز، ثم تأتي القفلة النغمية في قوله تعالى “فيه هدى للمتقين” على مقام البياتي، وتلوح لي اللطاقة الإبداعية في هذه التلاوة في الارتدادات بصورها الإبداعية المتراسلة، حيث يعود القارئ مرة أخرى إلى أول البقرة في لوحة حجازية مختلفة مستفزاً كل نوافذ التلقي الحميم والذائقة الجمالية الماتعة في سياق لحني شجي، في قوله تعالى ” بسم الله الرحمن الرحيم ألم ذلك الكتاب لاريب فيه ” هنا يقف القارئ بالسكتات والتنويعات النغمية في أ ل م ، مؤكداً على حيوية المعرفة الأكيدة والصوت المنتج والوعي المبدع، إذ يستحضر سامعه قلباً وقالباً فيما هو قادم داخل ما هو قائم، آية ذلك انتقاله الباني لعنصر الدهشة، وكسر أفق التوقع في مقام الصبا في قوله تعالى ” الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون”، والصبا من المقامات التي تتكاثف فيها طقوس الشجن والحزن، وهنا قد يرى البعض عدم وجود مسوغ تعبيري لمقام الصبا في هذه الآية لما فيها من عبودية وصلاة وتطوع وفرحة الرزق والفلاح، لكنني أرى أن الشيخ عمد إلى مقام الصبا لاختطاف السامع في جذبة هذا الوجد الصوفي تحقيقاً للعبودية والامتثال، واستغراقاً في الصلاة والوصل الرباني، وتزهيداً في بهارج الدنيا الزائفة بالإنفاق والتطوع، كل ذلك لا تتم ترجمته الإيقاعيه إلا بمقام حزين يتعقب أطوار الحركة الإنسانية بالترشيد والتوجيه، ويعمل على تشغيل كل مداركها الحسية والشعورية عبر مقام الصبا في صفو نبعه وعذوبة روافده وتراتيله الغارقة في تسابيح النص القرآني.
ويستمر الأداء التحويلي محافظاً على وحدة الخطاب النفسي في الآيات الكريمات إلى قوله تعالى ” أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ” على مقام الحجاز من درجة القرار بتوليفة تجمع الخيوط اللحنية في نسيج فني يتراوح طولاً وعرضاً وفق المقاصد الفنية والتعبيرية للشيخ الزناتي، وتبدوالصرخة الزناتية الفارقة التي انفرد بها عن سائر القراء،حيث يصعد ويلمع في درجات السلم الموسيقى في درجة الجواب في قوله تعالى “لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت”، ثم ينتقل إلى إحدى المقامات الشجية في قوله تعالى “ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا” وهومقام الرصد الذي يبدأ من العلامة دو – ري – مي نصف بيمول دو ، وقد اعتاد القراء والمنشدون والموسيقيون عند نزول السلم الموسيقي على استبدال السي نصف بيمول بالسي بيمول عادية، وفي هذا المقام يبلغ القارئ قمة السلطنة وذورة التفاعل الصوتي مع السياق النصي والدلالي في قوله تعالى ” ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ” ، وذلك في بنية نغمية يتحول بها إلى خريطة إبداعية تتخذ مواطنها في وسط السماء، وتقدم فلسفة القارئ لجماليات مكانه وجوهريات زمانه، ثم ينهى التلاوة بما هو معتاد بصدق الله العظيم على مقام البياتي لإيجاد الشكل النظامي للسيمترية العلمية في الأداء، وفي تصورنا العلمي أن هذا النموذج التحليلي يعد دليلاً كاشفاً على مرونة الصوت وهو يتدرج بلمسات زناتية خاصة من الطبقات الحادة العالية إلى النغمات الرخيمة في تراتب ثري وتسلسل يخط طريقه الواعد في التلوين النغمي والتقاسيم اللحنية، وفي رأينا أيضاً أنه لا يمكن اختزال الشيخ السعيد عبدالصمد في حنجرة ومصفوفة من الأحبال الصوتية، بل هو صورة صوتية تشرق في مرايا الزمان، وهو ميراث مشترك يتقاسمه الوجدان العربي والإسلامي سواءً بسواء، وإذا أمكننا القول : إن أهل القرآن وأولياء الله حشد من الطيبين البررة ، فإنهم في الوقت ذاته خلصاء لهم من النزاهة والقدسية حظ ، هكذا كان الشيخ الزناتي قديساً على سلم الإبداع والنغم .
في نهاية هذه السياحة التحليلية والنقدية في عالم الشيخ الزناتي، أرى أن صوت القارئ يعرب عن صورة سماعية تجمع شتات المشاهد في لوحة إيقاعية رسمتها ريشة وترية إبداعية استدعت في فناء اللوحة كل عناصر الصوت واللون والحركة في طلاقة صوت غير مسبوق في تكوينه وامتداده، صوت يترك العنان للصرخات أن تطغى بعفويتها، وللبحة أن تهمس برقتها، فله من الحبكة الفنية ما يجعله ماهراً في قطع خيط التسلسل بسكتات رقيقة جذابة، سكتات تقوم بدور الرابط الخفي بين فضاءات هذا الصوت الذي يملك استراتيجيات تتعالى على التوصيف النمطي المألوف ليدخل السامع على بوابات مرمرية مفتوحة على سجاجيد القمر الحريرية، يتلقى وحي رب من أرباب الآذان وقديسي الحناجر والأوتار، وها نحن أمام ثلاثين عاماً على رحيل الزناتي وذاكرة الدنيا تجدد خلاياها، ثلاثين عاماً وما زال البحر عاصفاً، والصدى صادحاً، والشمس تجري لمستقر لها، والشيخ على عرش ملكه الإبداعي تتبدل عليه الحكايات دون أن تسجنه حكاية أو يلخصه حكاء، فسلام عليه يوم وُلِد ويوم رحل ويوم يُبعث حياً.

 بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى