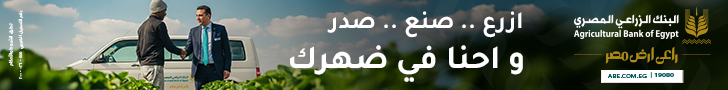بقلم الدكتور/ علي إسماعيل درويش
مدرس النقد والأدب السياسي بكلية اللغات والترجمة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيايأتي الحديث عن المادية والروحية حديثاً في الحياة وليس حكاية عن الحياة ، لأن إدراك الوعي الإنساني للقضية محل الطرح يستخلصه من قبضة ذاته وارتدادات نفسه، ويضفي عليه ألواناً من الكمالات التي تثري حسه بجوهرية وجوده في الوجود، ومتى استشعر الوعي الإنساني أن طغيان المادة يجعل المناهج الأرضية في أزمة دائمة، ويحيلها وجوداً عارياً من كل التزام، ويكرس إلى حضور بشري هارب في أودية الأنانية الباطشة، ترتب على الوعي ضرورة أن يعالج هذه الأنانيات والانفلات الضبابي بمسحة روحية طاهرة المنبع والمصب، لصهر القيم الأصولية في تضاعيف الوعي، وتدامج الروحي والمعرفي معاً، حتى يتيح للوجع الإنساني أن يعرض نفسه، وللعافية أن تزحف على آهات وأوجاع الجرح النازف، وإذا ما تم للوعي الإنساني ذلك، فقد صار صديقاً للوجود وللموجودات، يقيم من بناء الوجود ما تهدم، ويرفع من راياته ما سقط، ويشعل من مصابيحه ما أطفأته رياح اليأس وعشوائية الخبط والتخليط، ومن هنا تكون وصايا الحب والخير مناط المعرفة والسيادة والأهلية لفتح حوار مستمر وتخليق حس روحي، وإطلالة تغزل من خيوط الشمس أثواب الأمل، وتعزف على أنفاس المساء أنغامها الجاذبة، وفي العلياء يردد الأفق على شفاه الروح نوراً تعطر في سنا ألحانها ، فإذا الطبيعة على امتدادها في معية الروح تغرس في صحاري العمر أزهار المنى، وتصحب في تغريداتها وشوشة الجمال لهمس النسيم المسافر، وسحر الربيع المختال بعبق الروح الملهمة .
وتناول هذه القضية بالتحليل والنقد لابد أن يركن إلى حذر مؤسس على بداهة المعرفة وموضوعية الفقه وصوابية التحديد لترشيد الواقع والتحليق به لا فوقه، والحقيقة أن جمعاً من الفلاسفة قد وقعوا في هوة هذه الردة الفكرية والوجودية، وتعاملوا مع الوعي الإنساني تعاملاً أسطورياً أبكم فارغاً من المضمون، فأحالوا على ما هو ظلامي في هذا الكون الذي يضم ملايين من الارتفعات الشاهقة طلباً إلى السقوط البائس في غياهب اليأس، ومن العجيب حقاً أن البائسين يرفعون شعارات الاستسلام واللاجدوى، ثم هم مستعدون للدفاع عنها حتى الموت، ولو أنهم بذلوا هذا الجهد والعناء القاتل تحت راية الإيجاب والأمل، لأصبحوا جنوداً بواسل في طليعة الفدائيين من أجل حياتهم وحياة الآخرين، ولأطلوا على الدنيا من نوافذها المضيئة ، وليس تلصصاً من ثقوب الجدران البالية، وفي تقديري أن هؤلاء حين تشبثوا باليأس الرافض والتشاؤمية السالبة قد رفضوا مع هذا ما في الحياة من سقوط وتسطيح، لتجاوزوا الواقعية الهشة التي يعيشونها إلى واقعية متمردة على كافة جوانب الهشاشة التي تفضي في النهاية إلى العبثية والعدمية.
وامتداداً لهذا الحظ العبثي في ماديته السالبة نطالع الدرب الهلامي الذي يعاني انشطاراً روحياً فادحاً، فها هو العالم من وجهة نظر الفيلسوف الألماني “شوبنهاور” “العالم كله شر وسوء، والسعادة سلبية، والدين صناعة آدمية للهروب من شبح الموت”، وأنا لا أرى غرابة في كون هذا النتظير يُقعّد إلى فلسفة العدمية واليأس الحياتي والعقائدي، لأن إنكار الدين شر وسوء، ولا يمكن لأي توجه إنساني أن يحقق مراده مالم يكن في حراسة النمط التشريعي، فهذا الإنسان بمكونه المادي الطيني الأصل النطفي التخليق لابد أن يكون موصول الصلة بمصدره الأعلى السماء، كي يهاجر بكل ذراته إلى شوق الاحتضان في طبقاتها الروحية الشفافة، حتى يتأمل قضية وجوده بموضوعية تحصنه من التطوح في مجاهل الغرور والبوار، أما حين يصبح الدين صناعة بشرية، فإن العين ستنظر كرهاً، واللسان ينطق عداءً وهجراً، والشفة تتحرك بالعدمية جهراً، والعقل يفكر نكراناً وكفراً، وتصبح قوة الوعي مسلوبة من وسائط النظر والتعبير، ويغدو العالم كله محاطاً بأسباب ومسببات الشر والتعاسة، ومطارداً من شبح الموت في كل اتجاه.
هذا، وقد تبني نفس المنظور فلاسفة آخرون، وشكلت هذه الرؤية المادية منحاهم الفكري وعقيدتهم الفلسفية التي تداعى عليها ضمور الرؤى وبوار الإنجاز في كل منطقة حتى حدقت في زوايا الإعتام، وها هو ذا الفيلسوف الألماني “نيتشه” يؤسس هو الآخر إلى ” فلسفة العدمية الحضارية والمدنية وموت الآلهة “، وللقارئ الكريم أن يتأمل مردود هذه الفلسفة على الحاضر والمستقبل، وفي رأيي أن الحضارة تعني تحضر الإنسان نفسه لا تحضر ما حوله فحسب، الحضارة تعني تعالي القيم في الصورة الإنسانية الراشدة واعتصام الإنسان بالمبادئ السامية في مواجهة تميع الذات وتهتك الهوية وضبابية الرؤية وتشتتها، إذ إن كثيراً من هذه القيم تتعرض لمبادلات ساحقة، فالرجولة والمروءة عادت رجعية وتدخلاً فيما لا يعني، والحب أصبح تنازلاً وضعفاً، والآخر صار خصماً قبل أن تقع صورتك في صفحات عينيه، ولو تأملنا حقائق الفرق بين جوهر الوجود الإنساني وجوهر الأشياء، لأدركنا يقيناً كون الوجود الإنساني علامة تحول وقوة ودفع، بينما الأشياء وجود جامد لا يحقق لذاته أي موقف، وهذا دليل على سعة وقوة مكامن الطاقة في الوعي الإنساني، ومحاولة البعض وأد هذه الطاقة وتغييب الوعي انطلاقاً من تجارب ذاتية هابطة وخادعة يُلوّح بها الغير نقلاً وتقليداً ما هي إلا تجفيف لشرايين الوعي، وقطع الجسر الواصل بين المادة والروح، فمعاقرة الإدمان والمسكرات تبدأ من إغراءات غيرية توهم بها طائفة من المنحرفين لغيرها ما تحققه هذه المسكرات من لذة الإبحار في عوالم الغياب واللاوعي، وما ترسمه من رؤى ملونة وغياب يحلق بالغريزة في آفاق غير متناهية، حتى في العلاقات الجنسية نجد من يزين للآخرين فاعلية المخدر والمسكر، وكيف تنقلهم هذه الفاعلية إلى مساحات من النشوة تجعلهم على وعد ولقاء بالراحة والسعادة أينما حل المسكر في أجسادهم وعقولهم، وهكذا تتنامى هذه الدعوة لتشكل ظاهرة تهدد صلابة البناء الإنساني والوعي المجتمعي، وتدمر منطق الأشياء في قانونها الطبيعي، ولو أننا وقفنا بالوعي عند منطقة الميزان لعرفنا أن الغياب قد يعطي راحة عارضة وآنية، لكنه بالتأكيد يعقبه ضياع وهلاك، فالتخدير في لذة طارئة وجانحة عن مواجهة مصيرية ليس معناه الانتهاء إلى نتيجة أو حل، وإنما معناه تجاهل الحل وتناسيه إلى أن تتصاعد المشكلة وتتضاعف الأزمات، وحينئذ يرتطم الوعي بما لاطاقة له به.
أعود فأقول : إن قول “نيتشه” بعدمية الحضارة اندفاع جاسر بكل بلاهة إلى قطع الاتصالات بين الواقع والإدراك الإنساني، والفاجع في هذه الفلسفة أنها تجني حتى على المادة والميراث الحضاري، حيث يصرخ التردي في الخطوات وفي بريق العيون، وتغرق الحياة في ممارسات الجنوح والتفلت، وتزعم الحلم الرغيد وهي من البلادة الميتة والسكون الصريع على مسافة أشبار، والقول بموت الآلهة دليل مادي على عبثية الفلسفة وهشاشة مبناها ومعناها، إذ هي نتاج الإحباط والعجز والانكفاء على عتبات الانهزامية والتسليم، وإذا ما تابعنا سيرورة هذا الفلك الفلسفي سنصطدم بآراء “روبرت دارون” في نظرية البقاء للأصلح، و”ما رتن هيدجر” في كون القلق يكشف العدم والعدم بدورة يكشف عن الوجود، ينضاف إلى ما سبق قول الفليسوف الفرنسي الكبير “جون بول سارتر” بأن الوجود يسبق الجوهر، ولسنا بصدد التأريخ لتمدد هذه الظاهرة الفلسفية عند السابق واللاحق، فكم تقدم الصبح من فجر كاذب، وكم سبق العروس خاطب عاطب، لكن الذي يطمئن إليه رأينا العلمي أن هذه الآراء ماثلة في ثياب رث مرقع بالمقولات الجاهزة الهاربة، الأمر الذي يحتم علينا تعريته لكشف هذا الجسد المشوه بطعنات التأليه الساقط للمادة والعابد لخوفه وطموحة معاً.
ولا يمكن لأحد أن يتصور أنني أصطدم بالفكرالغربي إعمالاً للذاتية أو الهوى، فمن المعروف عني في الأوساط العلمية أنني واحد من المهتمين والمفتونين بدراسة وتحليل العقل الأوربي والأمريكي سياسياً وأيديلوجياً وفلسفياً وفنياً، لكن هذا الشغف والانبهار بالفكر الغربي أمارسه بحيادية وتجرد، أمارسه بدون تبعية وتملق، أوتنكر له أو تصادم معه بسبب ولاء عرقي أومذهبي، فأنا في النهاية محكوم بكوني وصفتي أستاذاً للنقد، ومادام ذلك كذلك فإن إنكار الألوهيه تجسيد لعبودية ساقطة ومادية ساحقة، إذ الكون مخلوق علي قانون الأسباب والمسببات، فالنار تحرق، والماء يروي ويغرق، وتوقف القلب يميت، وفي تقديرنا الشخصي أن تمرير كثير من الجرائم الحضارية التي اقتلعت الإنسان من أمانه وزمانه مردها إلى توحش طوفان المادية، وتكاثف عبودية الإنسان للإنسان مالاً وموقعاً وغريزة وصولاً إلى السقوط في خنادق القتل والتدمير، لأن الدعوة التي تستجيب لحس الهبوط في أتباعها دعوة تفريغ، أما العفاف الروحي فهو يتعالى بالوعي الإنساني عن الإلحاد ، ويعزز فيه سلامه الداخلي، ويربأ به أن يكون وثنياً يلهث ضعفاً وشوقاً إلى إله مزيف من المال أو الجاه، أو أي عرض من أعراض المادة الزائفة.
ولقد عالجت الشرائع السماوية هذا التطلع المعرفي إلى الماورائيات، فتعاملت برفق وتعاطف مع محدودية العقل البشري، حتى لا تسكنه الريبة والوساوس سكون الإثم في الضمير، ولنأخذ من النماذج الحية للمادة مثالاً ليس بالجديد الطارئ على المساجلات الفكرية والجدليات الفلسفية، وهو الحج، إذ ترى قطاعات من الأقلام الغربية والعربية معاً أن الطواف حول الكعبة وتقبيل الحجر الأسود عبودية وتوثين للأحجار، وفي رد القدماء والمحدثين على هذه الأقلام ما يغنينا عن الاستطراد في مواجهة هذه الآراء، لكن الذي أراه وأؤكد عليه أن الذين يجدفون بلاوعي قد غابت عنهم صيحات الشرائع السماوية، وهي لا إله إلا الله، وآخر صيحة في الرسالات هي ما استوحى محمد ترديداتها من السماء مؤكداً على التنزيه عن الشركية ودعم الحركة الناهضة في جوهر التوحيد، فقد أتاح للإنسان أن يتعالى عن الذل أمام نار أوحجر أو شجر أو بقر، وأن يظل في إيمانه عبداً لله وسيداً على كل ما حوله، أما حكمة هذه العبادة ففيها ما هو مرئي ومنظور، وفيها ما هو غير منظور وأكبر من طاقة الاستيعاب الإنساني، أما ما هو منظور فتوثيق المكان بالزمان من حيث كون الحج أشهراً معلومات، أيضاً تحقيق للطبيعة المنشودة في قانون هذه العبادة واستجلاء ما يكمن وراءها من أسرار روحية وقيم نفسية ومعطيات إيمانية، ففي الإحرام رفعة عن جواذب الحياة وقبضاتها الرخيصة والوقوف على خط تماس واحد أمام الله تبتلاً وصلاة ودعاءً، فالملك والمعدم والأبيض والأسود كل يلبس إزاره، ويبحر إلى خالقه خالعاً عنه دنياه إلى دينه، أما ما هو غير منظور وأكبر من طاقة الوعي في الحكمة من هذه العبادة، فهو الرحمة بمحدودية وحصرية الإنسان، وليس القهر أو المصادرة على وعيه وحريته، ليترك جوهر ما يفعله وما يبتعد عنه إلى القوة الكبرى التي تملأ وعيه بما يطيق من فهم وتحجب عنه مالا يطيق، إذ القائد في ساحة المعركة يحجب عن جنوده بعض المعلومات والأسرار حفاظاً على حياة الفرد والمجموع، والدليل على ذلك حينما سُئل االرسول عن ماهية وكنه وكيفية الروح، رد القرآن بقوله :”وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ” (سورة الإسراء :85)، لهذا فإن الله أرحم بعباده من أن يكبدهم محاور وآثار الفهم الكلي والشامل لمكونات الظواهر الكونية والعقائدية والماورائية، لأن الظاهرة الكونية نحن البشر بعض مفرداتها، فكيف يمكن استيعاب شمولها المعجز، وكيف يمكن للبعض الإحاطة المطلقة بالكليات الخارقة، ولا يُمكِّننا الوعي حصر كل المفردات التي يمكن أن تبوح بها وضعية أن يكون لله بيت في الأرض، فهذا فوق قوة العقل وطاقة الحصر وإمكانية الاستقصاء، لكنها تكشف بما تفيض به من معاني الحق وتحريك العقل في اتجاه التوحيد، لمباركة الله لعواد بيته وإطلاله عليهم إنماءً للزهور النابتة في وجدان ضيوفه وإشراقاً باسماً في وجه الأخوة الإنسانية لا وجه الأخوة النوعية أو الطائفية .
واتساقاً مع كابوسية التصنيف النوعي والمذهبي عانت الإنسانية من زحف المادية وتوابعها التدميرية حضارياً وسياسياً وعسكرياً، حيث شكلت صفحات سوداء في تواريخ الأمم والشعوب بدءاً من المد التتاري العاتي وما خلفه من هتك وضياع وصولاً إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية مروراً بحرب البوسنة والهرسك والاحتلال الأمريكي للعراق، انتهاءً بما تمارسه إسرائيل من عدوان فاحش في حق الشعب الفلسطيني تحت غطاء أمريكي فاضح، هكذا اعتاد المحاربون في تحقيق غاياتهم على خوض حمامات من الدماء لا حدود لها، واعتادوا أن يعبروا إلى أهدافهم دهساً على الأشلاء الكونية والإنسانية معاً ، لكن محمداً وقف من هذه القضية موقف النقيض وهو يواجه أبشع قوة عدوانية طاردت الإنسان على حساب الانتماء واللون والهوية، ففي أسوأ مواقف الحرب وأشدها نراه يوجه الجيش الإسلامي بقوله ” لا تقطعوا شجراً، ولا تقطعوا زرعاً، ولا تردموا آباراً، ولا تقتلوا وادعاً… ” إن محمداً في أعقد الظروف يقيم صداقة بين الحياة والأحياء، ويقرع أسماع من داسوا القيم بأقدام غلاظ، فالحرب بأحقادها العدوانية الباطشة لم تستثر حفيظته ضد الحياة، ولم تستدرجه إلى كراهية الوجود في كل مظاهره، الإنسان والنبات والجماد، فالحضور العسكري لا يفقد وجوده الملتزم أمام روعة الموجودات، حيث منعته روحانيته من المساس بالأبرياء الآمنين، بل كان التعاطف مع الشجر والزرع والثمر والماء قاعدة أرستها شخصية محمدية تربأ أن تقطف الثمار ثم تقطع أشجارها الواهبة، في هذه الطقسية الحربية الحالكة تأكيد على أن القيم الروحية ليست جزيرة معزولة في محيط، ولكنها طرف جدلي في علاقة كلية لابد أن تضيء بكاملها، وبهذا وضع محمد قبلة على خد الحياة، وتوج رأسها بطوق لؤلؤي تتناثر أضواؤه وتتألق أنواره شمساً تحيي في الحياة أجمل ما فيها ومن فيها .
 بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى